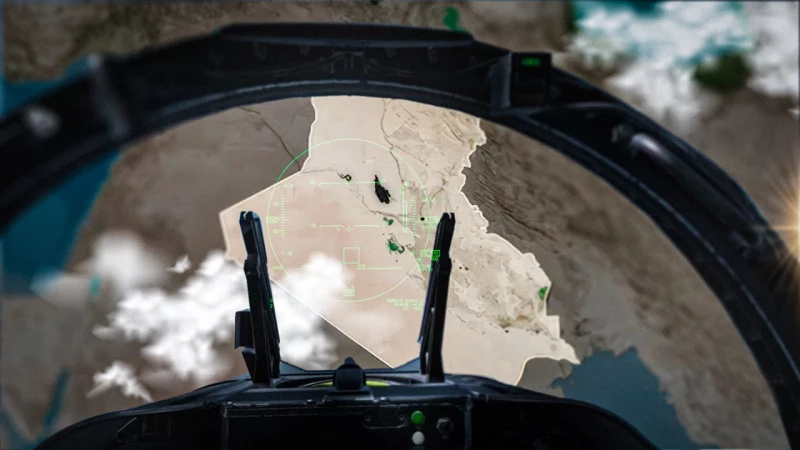أياً كان من وضع حدود العراق الحديث، المس بيل أم مستشارو وزارة المستعمرات البريطانية، فإنها مقاربة بشكل كبير لحدود العراق التاريخي، الذي نجد ذكره في مصادر تاريخية عديدة، ومنها قول المسعودي: (حده مما يلي المغرب وأعلى دجلة من ناحية آثور وهي الموصل. ومن جهة المشرق الجزيرة المتصلة بالبحر الفارسي المعروفة بميان).
كذلك، فإن اختيار فيصل بن الحسين الهاشمي ملكاً على العراق (1921-1933) كان اختياراً مناسباً جداً لطبيعة المجتمع العراقي. فهو مجتمع أبوي بشكل عميق [حتى ساعتنا هذه]، ويبجّل السادة من نسل الرسول، ومن بين كلّ من يدّعي الانتساب الى النبي العربي في العراق والمنطقة العربية، فإن عائلة أمراء مكّة هم الأكثر موثوقية باتصالهم بالنسب الهاشمي.
النقطة الأخرى المهمّة؛ أن مشروع الحكم الهاشمي جاء على رافعة المشاعر القومية التي أنهت شرعية الحكم الديني [للباب العالي في اسطنبول]، لهذا فهو مشروع حداثي، أو يمزج بين المشروعية الدينية [حكم قريش لثلاثة ارباع التاريخ الاسلامي العربي] والرافعة القومية الحداثية التي انبعثت أول مرّة من الديار الأوربية كردّة فعل على انهيار الامبراطورية الرومانية المقدسة والفتوحات النابليونية، ثم انتشرت في أرجاء الامبراطورية العثمانية وأراضي المستعمرات القديمة.
بدأ حكم فيصل الأول بصدامات شرسة مع قطاعات من الجماعات العراقي التي يراد لها أن تكون "مجتمعاً عراقياً" ومواجهة أيضاً مع مرجعية النجف، لكن هذا انتهى لاحقاً إلى نوع من التفاهم والتخادم ما بين كرسي الملك في بغداد وبرّاني المرجع في النجف، فلا يكسر الملك احترام المرجع ولا يناهض المرجع شرعية الملك، ثم صار التقارب بينهما أقوى مع انتشار المد الشيوعي بين الشباب العراقي.
نموذج السلطة الأبوية في الحقيقة ظلّ هو البوصلة المهيمنة لمسار الحكم في العراق. لقد تحوّل عبد الكريم قاسم سريعاً، ما بعد اسقاط النظام الملكي في 1958 صورة جديدة لـ"الأب الراعي" للعراقيين، ثم جاء صدام حسين ليكون أباً أيضاً، ولكن بنسخة مشوّهة عن فيصل الأول.
صدّام كان يحكم مثل ملك مطلق، وكان من المرجّح أن يورّث السلطة لأحد ولديه، وانتسب إلى الهاشميين أيضاً، وكان عروبياً وتقدّمياً، وهذه كلها مشتركات مع فيصل الأول. ولكن ما سوى هذه التشابهات فإنه يختلف كثيراً، بسبب رعونته وتهوّره وطموحاته ومغامراته الكارثية التي جرّت الويل والثبور على البلاد.
لم يتحرّك الكثير من الناس إلى الانتخابات في 2005 إلا بإشارة أبٍ هاشمي آخر، هو مرجع النجف، وما زالت السلطة الأبوية للمرجع فاعلة على مختلف الأصعدة.
نحن نحلم بمجتمع مكوّن من أفراد كاملي الأهلية، واعين ومستقلين، ولكن الواقع يخبرنا بأن السلطة الأبوية ما زالت قوية ومؤثرة، وجذرها وأساسها من الثقافة الاجتماعية، والتي لا يكون للدين فيها بالضرورة دور بارز، وانما هي الأعراف والعادات العشائرية والقبلية والتي تؤثر على حياة الغالبية من العراقيين، بشكل أو بآخر.
كان تعامل البريطانيين مع زعماء العشائر العراقية العربية والكردية والتركمانية على أنهم "لوردات" محليين، يتّسم بشيء من الوجاهة، وكانت بعض هذه الزعامات قد وجدت طريقها، بعد جيلين، إلى سبل التمدّن والتحضّر، وصار بعضها يتصرّف من وحي المسؤولية الاجتماعية، وأن الزعامة تأتي بأعباء ورهانات يجب الإيفاء بها أمام المجتمع.
عبرت بعض الزعمات، مع الجيل الثاني والثالث، إلى مناصب وشهادات عليا، وصارت أكثر انفتاحاً، وناقلاً مهماً للقيم الحديثة الى بيئات العشائر والقبائل. وكان من الممكن الافتراض أنها ستأخذ بالتطوّر التدريجي لولا القطع الذي مثّله انقلاب 1959، والذي أنتج نمطاً جديداً من الزعامة لا صلة له بالأصول الاجتماعية، فهؤلاء مجموعة ضبّاط من الهامش الاجتماعي، تسلّموا مقاليد الحكم باستثمار موارد الدولة نفسها التي انقلبوا عليها.
وصف رجالات الطبقة السياسية الجديدة ما بعد 2003 بأنهم (آباء العملية السياسية)، ولكنّ قلّة منهم كان على قدر المسؤولية التي تترتب عليها صفة الأب، ولم يفكّر أغلبهم بالتراث الذي يكوّنونه ويورّثونه للجيل الجديد من السياسيين، وتعاملوا مع المسؤوليات والمكاسب بتصوّر صفري، يرى فيها فرصة، وليست أفقاً يمكن أن يتطوّر ويمدّ أسبابه الى المستقبل. وبعد أكثر من عشرين سنة ما زالت صورة "الأب الراعي" الذي يمّد ظلاله على كلّ العملية السياسية وكل العراقيين، شاغرة وغير متحقّقة، وربما لن تتحقّق أبداً.