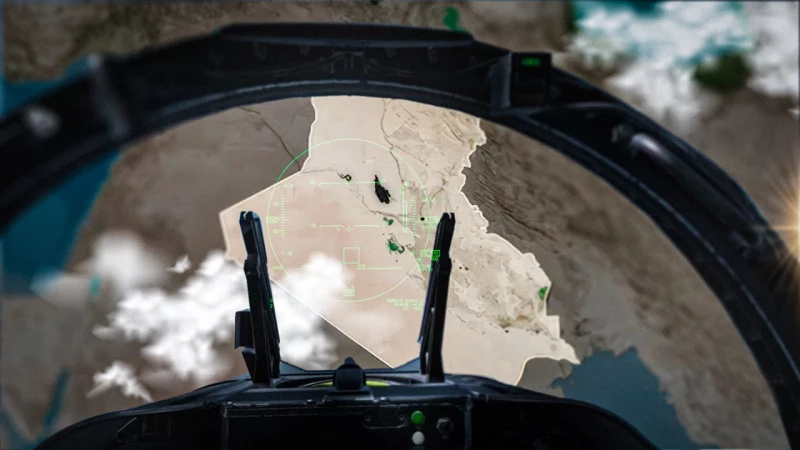في التظاهرات التي استمرّت في البصرة على مدى صيف 2015 احتجاجاً على انقطاع التيّار الكهربائي وسوء الخدمات في المحافظة، تحرّك فصيلٌ مسلّح تابعٌ لأحد أحزاب السلطة، لحماية المحافظ الذي ينتمي إلى ذات الحزب. وكان هذا الفصيل قد تأسّس أصلاً للاشتراك ضمن قوّات الحشد الشعبي، ولقتال العصابات الإرهابية التي احتلّت الموصل وتواصل نزولها إلى مدن أخرى مختلفة.
كتبتُ وقتها تغريدة على منصّة تويتر (X) انتقدتُ فيها ترك هذا الفصيل مهامَّه القتالية المفترضة، والذهاب لقمع متظاهرين وحماية مسؤول سياسي فاسد.
لم أكن قد اخترقتُ منطقةً محرّمة أو جئتُ بشيء جديد، فهو إيقاع التعليقات على الشأن العام الذي كنتُ أواظب عليه منذ احتجاجات 2011 في بغداد على الأقل. لكن في اليوم التالي، رأيتُ كيف أنّ هناك حملةً ضدّي قد تكوّنت في مواقع التواصل كلّها، وصلت إلى حدود تهديد سلامتي الشخصيّة. وانبرى في وقتها مثقفون وإعلاميون عراقيون للدفاع عنّي، ومنهم الكاتب والروائي العراقي الراحل حميد العقابي، الذي كان مقيماً في الدانمارك، ولم تكن لي سابق معرفةٍ به، حيث كتب على صفحته في فيسبوك، يدافع عنّي ويقول بما معناه: لا تجعلوا سعداوي يغادر بغداد.
الذي حصل في وقتها، بعيداً عن الجانب الشخصي، هو مؤشّر على تغيّرٍ في المزاج؛ مزاج السلطة والتركيبة الداخلية فيها، ونوع الجمهور الذي صار يدافع عنها، حيث خرجت الميليشيات من العتمة لتكون في صدارة المشهد السياسي والأمني، وصار السياسي الفاسد يحتمي بها كي يجدّد صورته، بعد إخفاقه الهائل الذي أدّى إلى كارثة سقوط ثلث العراق بيد الإرهاب.
لم يعد وجه السلطة الجديد، ذي القسمات الميليشياوية، قادراً على تقبّل النقد، وصار أكثر جرأةً ممن سبقوه في استهداف من يراهم خصوماً، بل وقد يهدّد حياتهم وسلامتهم الشخصيّة، ثم تطوّر الأمر إلى تشويه السمعة والصورة.
دائماً ما أقول إنّ لحظة حزيران 2014، مع سقوط الموصل، هي لحظة فاصلة على أصعدة كثيرة، ومنها حريّة التعبير. إنّ انفجار تشرين الأوّل 2019 ووقوف الشباب عاري الصدر أمام نيران المسلّحين في ساحة التحرير ببغداد وغيرها من الساحات، بما يشبه النَّفَس الانتحاري، هو من نتائج التحوّل الذي حصل قبلها بخمس سنوات، حيث أُقفل الفضاء العام، وارتفعت محرّمات جديدة، سياسية وعقائدية، وصار النقاش والحوار حول القضايا الحسّاسة التي تخصّ وضع البلد ومستقبله يمرّ عبر فلتر مزاج المليشيات، وهو ما استمرّ حتى الساعة، بكلّ أسف.
لم يكن وضع الحريّات العامّة مثالياً قبل حزيران 2014، ولكن كان لدى الصحفيين والناشطين والكتّاب والمثقفين هامشٌ معقول يستثمرونه في الدفاع عن سلطة القانون والدستور، والمطالبة ببناء المؤسسات، والضغط الفعّال على السلطة، من خلال المنشورات والاحتجاجات والتظاهرات، من أجل المزيد من الإصلاحات الضروريّة.
عاش متظاهرو تشرين الحريّة التي يريدونها لفترة وجيزة داخل ساحات الاحتجاج، ولكنّها لم تمتدّ إلى قبّة البرلمان ومؤسسات الدولة والنظام السياسي بشكل عام، لأنّ النظام لم يكن مستعدّاً لإجراء أي تغيير أو إصلاح، وهو غير مستعدّ لذلك حتى الساعة.
إنّ الاستجابة للضغوطات الخارجيّة ومحاولة تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي، ليس منهجاً سليماً للإصلاح، فما إن يتوقّف هذا الضغط حتى تبرد ماكينة النظام السياسي. ومن الغريب أنّه يشعر بالقلق لما يقوله الآخر، الغربي والأميركي، ولا يهتمّ لرأي المواطنين والنخب في الداخل، ولا حتى مرجعيّة النجف التي يدّعي النظام أنّه يحترمها.
إنّ فقدان الحريّة في الكلام، والشعور بالخطر من محاولة النقد، يعطّل إمكانات المجتمع برمّته، ومساهمة النخب فيه في اقتراح الحلول وترقية الوعي العام. لذلك فليس من الغريب أن نشهد مقاطعةً واسعةً للانتخابات في 2018 و2021، وهي استجابة متوقّعة أيضاً مع انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام.
فالحريّة يجب أن تكون واحدة؛ حقّ المواطن في الكلام والاعتراض والاحتجاج والنقد بالوسائل المشروعة، وحقّه في الحياة بكرامة تحت سلطة دستور وقانون نافذ مفروض على الجميع، وحقّه في الانتخاب.
النظام الذي ينتهك الحريّات العامّة والقوانين ونصف موادّ الدستور كلّ يوم، ويهندس الانتخابات على مزاجه لا ينتظر من المواطن أن يحترمه، أو يرى فيه أملاً بالإصلاح والتغيير.

 احتجاجات مطالبة بالخدمات في البصرة - 2018 (الشرق الأوسط)
احتجاجات مطالبة بالخدمات في البصرة - 2018 (الشرق الأوسط)