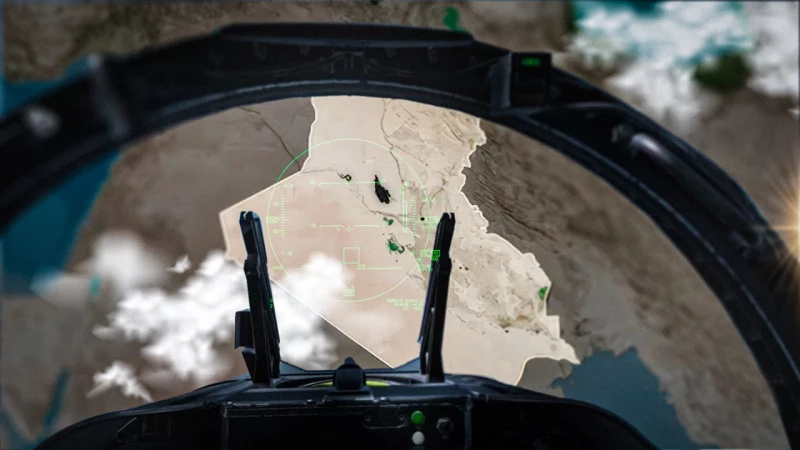لم تطرأ متغيرات عميقة في جوهر حرية الصحافة والإعلام بعد تأسيس الجمهورية الرابعة في العراق، كما كان مخططاً له أن يرافق التحول الديمقراطي الجديد في تلك البلاد، على الرغم من الضمانة الدستورية التي جاء بها دستور عام 2005 في المادة 38 منه، والتي نصّت على أن (تكفل الدولة بما لا يخل في النظام العام والآداب العامة أ- حرية التعبير عن الآراء بكافة الوسائل ب- حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر) إلا أن تلك الحرية بقيت مقيدة إجرائياً وتشريعياً، وأحيانا مجتمعياً أيضاً.
من الناحية العملية، فإن الدستور قُيد في العراق ليس على مستوى حرية الصحافة وحسب، وإنما على مستوى بناء دولة ديمقراطية حديثة، حتى أن بعض فقهاء القانون يعتقدون أن البنية الأساسية للدولة لم تبنى على أساس الدستور، كما أنها غير محكومة به أيضاً، حيث عجزت الهيئة التشريعية بعد مضي نحو 17 عاماً عن تشريع ما نسبته 70 بالمئة من القوانين الدستورية، كما فشلت الدولة في إتمام مهام الكفالة الدستورية من حيث الضمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والتعليم وغير ذلك.
بقيت الدولة محكومة بثلاثة مقابض رئيسية تحكم مفاصلها وتنظم العلاقة بين مؤسساتها وسلطاتها على حد سواء مقابل تنظيم علاقة تلك المؤسسات مع الأفراد.
والمقبض الأول هو اجتزاء ما هو مناسب من الدستور وتعطيل الجزء الآخر منه لأسباب سياسية، وأفضى هذا السلوك بطبيعة الحال إلى الإضرار بالبنية الدستورية للدولة، أما المقبض الثاني؛ هو اجترار النصوص والقوانين التي شرعت إبان حكم نظام حزب البعث من 1968 إلى 2003 وإعادة تفعيل العمل بتلك القوانين التي بالغالب تكون منافية للثوابت الدستورية، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير عن الآراء وحرية الصحافة.
المقبض الثالث هو النتيجة الذاتية التي تمخضت عن تحالف المبقضين السابقين، لتنتج عرفاً سياسياً امتد إلى الدولة ومؤسساتها، واستتند بالدرجة الأساس للمصلحة الحزبية والمكوناتية التي تستحصل بالعادة من أبعاد ديماغوجية انفعالية، دون النظر إلى الإلزام الدستوري وأحقيته في نقض تلك القرارات، أو القوانين التي تصدر من الهيئة التشريعية.
اتكأت المصلحة الحزبية في التشويه المتعمد للدستور لإسباغ حالة من الشرعية على الحاجة الناشئة من جراء النزاع على السلطة على قرارات تصدر من المحكمة الاتحادية (*غير الدستورية، على اعتبار أن قانونها لم يشرع دستورياً) نتج عن ذلك حزمة من القرارات الباتة والملزمة التي ساهمت بشكل أو بآخر بتجميد الدستور وإحلال حزمة قرارات موازية أو بديلة عنها، كما شرعنت التابوهات السياسية والعشائرية والدينية ضمن قوانين أو قرارات ماسة بحرية التعبير، كتبت بالعادة لتحقيق حاجة سياسية ضمن الصراع المستعر على السلطة.
"الدستور الموازي"، إذا جاز أن نسميه، أسس إلى حالة جديدة تبدو غريبة وغير منضبطة وربما أجنبية عن الدستور نفسه، ولعل التحدي الأساس هو إعادة الدولة إلى نصابها الدستوري قبل تبني مفهوم التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها بحماسة من قبل النخب السياسية والمدنية كلما أشتد الصراع السياسي. إنّ هذه الحالة ساهمت بطريقة مباشرة إلى تشديد القيود المفروضة أصلاً على حرية التعبير عن الآراء وأختها التوأم، حرية الصحافة والإعلام، كما حُرم الصحفيون قسراً من تشريعات تمكنهم من الوصول إلى المعلومات من مصادرها، بل يتم حجب المعلومات عن الصحفيين باسم القانون.
التمويل بوصفه عاملاً محفزاً للحرية
وفي ظل استحواذ الأحزاب على مؤسسات الدولة، ساد المال السياسي وتحول من مراحل التمكين الجزئي إلى مرحلة الهيمنة المطلقة. أنبرت الأحزاب والتيارات السياسية إلى تأسيس وسائل إعلام مختلفة تدافع عن أيديولوجياتها ومتبنياتها السياسية، وسرعان ما تأثر الجو السائد في تداول المعلومات أو نقلها إلى الجمهور بهذه الأيديولوجيات المتفرعة. يمكن القول إنّ نسبة الإعلام الممول من المال السياسي يغطي المساحة الإعلامية في العراق بشكل شبه مطلق، حتى تلك التي تندرج على أنها مستقلة تتلقى أموالاً سياسية تُجبر الصحفي على تبني آرائها الساسية التي تترنح حسب الجهة المانحة، الأمر الذي جرد وسائل الإعلام من وظائفها الرئيسة في عملية نقل المعلومات وتحليلها والتعاطي معها بشفافية أمام الجمهور العام.
في الواقع لم ينتج في العراق إعلاماً مستقلاً بسبب اقتصاده الريعي وتحكم المال السياسي، وهو واحد من أبرز الأسباب التي تقيد الحريات الصحفية، وتحيلها إلى عرف هجين يتسم بالفوضى ويفتقر في الغالب إلى الشفافية والمصداقية.
غاب الاستثمار في الإعلام وغابت معه المؤسسات الإعلامية التي تبتغي الربح في عملية تسابق صارمة في إقناع الجمهور بعمق المادة الصحفية والتدقيق في المعلومات والأخبار المنقولة عبر منافذها المتعددة، واندثر التنافس المهني المحض وتحول تدريجياً إلى واحدة من أدوات وأسلحة الصراع الحزبي.
الرقابة الدستورية على الإعلام
لم يحدد الدستور أي نوع من أنواع الرقابة على الإعلام، بل أنه بالغ في فسح الحرية على الطريقة الليبرالية، لكنه في ذات الوقت لم يضع الضوابط الواضحة لخضوع الرقابة الذاتية على الإعلام، حيث نصت المادة (38ب) "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر"، وفي نص هذه المادة هناك تناقضان مهمان ترنحا بين القيد والإطلاق؛ فأما القيد، فهو يتعلق بربط الكفالة الدستورية بمخالفة النظام العام والآداب العامة والتي لم تحدد في المنظومة التشريعية العراقية، وهو أمر يترك مساحة الاجتهاد والتفسير والتأويل مفتوحة، لاسيما وأن الآداب العامة ليست ثابتة وتتغير طبقاً لعادات المدينة أو المحافظة أو الإقليم، ومن الواضح أن الآداب العامة في النجف أو كربلاء تختلف عنها بالمجمل في السليمانية مثلًا أو العاصمة بغداد، وأما الإطلاق هو عدم تذييل النص بالتنظيم القانوني وبقيت المادة مطلقة "والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة"، ومن الواضح أن المشرع تجنب فرض قيد أو شرط على حرية الإعلام والصحافة وأرادها مطلقة غير مقيدة، لكن هذا لا يمنع تنظيم وسائل الإعلام وإخراجها من مراحل الفوضى انطلاقاً من وظيفة الدولة الأساسية: "حماية مصالح رعاياها" وواحدة من الضوابط الثابتة هو حماية المواطنين من التضليل الممنهج أو التعمية من خلال حرمان المواطنين من استقاء المعلومات من مصادرها بانسيابية وحيادية وموضوعية.
وبدل أن تذهب الهيئة التشريعية إلى إصدار قوانين تنظم عمل وسائل الإعلام، استندت على اجترار قوانين من النظام السابق منافية تماماً للمبادئ الديمقراطية التي جاء بها الدستور مثل المواد 81\82\83\84 التي وردت في الفصل الثالث (المسؤولية في جرائم النشر) في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي كان قد عُلق العمل بها إبان حكومة الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة الأميركي بول بريمر عام 2004، لكن سرعان ما عاد تفعيلها في عام 2008 ورفع التقييد عنها على اعتبار إلغاء قانون إدارة الدولة المؤقتة والأوامر التشريعية لبريمر، ولم يشرع مجلس النواب طيلة الدورات الخمس المنصرمة سوى قانون يتيم باسم (قانون حقوق الصحفيين) رقم 21 لسنة 2011 وهو قانون كرس التقييد ونافى الثوابت الدستورية حسب ما أدلى به مختصون من آراء، حيث ورد في المادة 6 من القانون واحدة من المواد التي تكشف تقييد الحقوق المطلقة للصحفيين، ألا وهي الاطلاع على المعلومات من مصادرها حيث نصت المادة "للصحفي الحق في الاطلاع على المعلومات من مصادرها مالم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً على المصلحة العامة".
وهنا يرد الإشكال الواضح في مكامن التشريع أو نوايا المشرع؛ من الذي يحدد نوع المعلومات التي تشكل ضرراً على المصلحة العامة؟ إن كان الموظف المختص كما ورد في القانون، فبإمكانه ووفقاً لنص المادة، إخفاء أي معلومة يشاء بدعوى أن إفشاءها يشكل ضرراً على المصلحة العامة، كما أنّ القانون انشغل بشكل ملفت إلى منح الصحفيين امتيازات عينية ومادية تنافي نص المادة 14 من دستور عام 2005، والتي تنص: "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز".
افتقرت المنظومة القانونية في العراق إلى قوانين ناظمة لعلاقة الصحفي بمؤسسته أو علاقة المؤسسة بالدولة أو المجتمع، كما ارتدت عملية الرقابة على الإعلام ارتداداً طبيعياً باتجاه قوانين الأنظمة الشمولية، ومنحت السلطة العامة ـ في ظل غياب القانون المنظم ـ إلى فرض القيود على عمل الصحافة، ولم يترجم الإلزام الدستوري إلى واقع عملي ينعكس باتجاه تحرير الصحافة والإعلام من سطوة السلطة العامة أو من يمثلها من مؤسسات أو أشخاص أو حتى أحزاب وتنظيمات سياسية، وحري بنا أن نذكر إن العراق يتصدر دول العالم في اغتيال الصحفيين بنحو 400 صحفي بسبب ما عمله أو أدلى به من آراء، كما أن العراق يتصدر أيضاً دول العالم بالإفلات من العقاب، حيث لم يقدم إلى العدالة سوى 8 جناة فعليين من أصل 413 حادثة اغتيال منذ العام 2007 إلى العام 2020.

 العديد من الإشكالات حول تعامل المنظومة القانونية مع الإعلام
العديد من الإشكالات حول تعامل المنظومة القانونية مع الإعلام