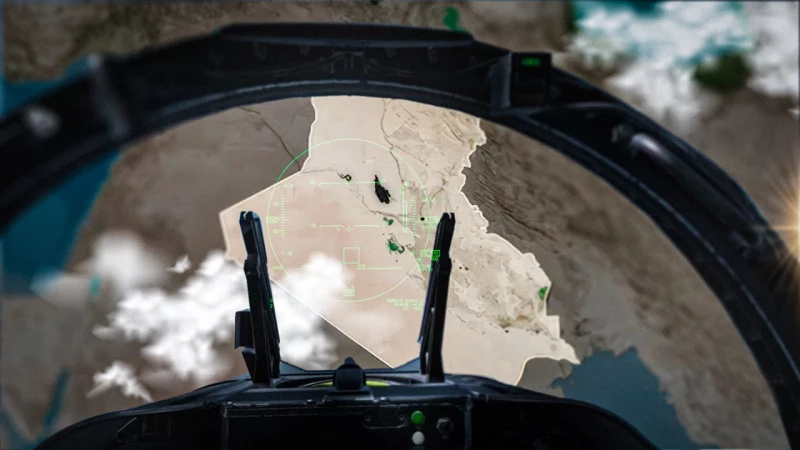منذ أكثر من عقدين، ظلّ العراق محاصراً بين الاحتلال الأجنبي والهيمنة الإيرانية، يتنقّل في السياسة الخارجية بلا هوية واضحة، ويُستثمر كأداة لا كدولة. لكن السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ أحداث سوريا وتحولات ميدانها، فتحت نافذة استراتيجية نادرة لبغداد كي تعيد رسم تموضعها الإقليمي بهدوء، وبخطوات محسوبة. بغداد اليوم لا تنقلب على أحد، لكنها أيضاً لم تعد تقبل أن يُدار قرارها من خارج حدودها.
في هذا السياق، تتبلور أمام الغرب فرصة ثمينة: العراق، كما لم يكن منذ سنوات، يبني لنفسه موقعاً مستقلًا بين القوى المتصارعة. والغرب، إن أراد استقراراً مستداماً في الشرق الأوسط، يجب أن يصغي لصوت بغداد الجديدة.
من التبعية العمياء إلى التوازن
لأعوام طويلة، اتسمت سياسة العراق الخارجية بالخضوع لمحاور الإكراه، كانت قراراته الخارجية إما منفعلة أو مشروطة، يديرها توازن داخلي هش يفرضه واقع السلاح غير الشرعي والضغط الإقليمي. إلا أن حكومة بغداد الحالية، مستفيدة من لحظة التخلخل الإيراني في سوريا ولبنان، بدأت في إعادة تموضع واضح؛ تموضع لا يقطع الجسور، لكنه يرفض أن تُبنى هذه الجسور من طرف واحد دون رأيه ومصلحته.
بغداد تتحرك اليوم بمنطق مختلف "دولة ذات مؤسسات دستورية، تبحث عن شراكات، لا تبعية فيها". توازنٌ لا يعني الحياد السلبي، بل استقلال القرار، والانفتاح على الجميع من موقع السيادة التي تحاول البلاد استعادتها ولو كلفها ذلك اضطراباً في قواعدها الداخلية والخارجية السابقة.
مؤشرات التحول الفعلي
لم يعد هذا التحول مجرد خطاب أو نوايا، بل اتخذ مظاهره في أفعال ملموسة على الأرض:
في سوريا
عندما اندلعت حرائق اللاذقية هذا الصيف، تحركت بغداد بسرعة نادرة، وأرسلت فرق إطفاء كاملة عبر وزارة الداخلية العراقية. خطوة أثارت الاهتمام، ليس فقط لإنسانيتها، بل لأنها جاءت مستقلة عن التنسيق الإيراني التقليدي، وتعبّر عن توجه مباشر في العلاقة مع دمشق، دون وسطاء أو أجنحة عسكرية موازية سيما وأن بغداد فاجأت الجميع بتحركها تجاه دمشق وما سبقه من لقاء الدوحة.
على الصعيد الدولي
أعادت بغداد تفعيل تعاونها مع الإنتربول، وسلّمت مطلوبين دولياً بعد سنوات من المماطلة، كما فعلت ما هو أكثر رمزية: أزالت العراقيل التي كانت تعطل نظام BICES الخاص بتبادل المعلومات مع حلف الناتو، بعد أن كان يُستخدم سياسياً وفق التوازنات الداخلية. ذلك يعني التزاماً حقيقياً بالمنظومة الدولية، بعيداً عن لعبة المحاور.
إلى جانب الملفات الأمنية، بدأت بغداد ترسم ملامح خطاب إقليمي جديد. فهي لم تعد تتحرك كذراع لأي محور، بل كدولة تفكر بمنطق المصالح، وتتحدث بلغة المؤسسات.
ففي سوريا، أرسلت شحنات من الحنطة رغم نقص المخزون المحلي، كرسالة تضامن سياسي وإنساني تتجاوز الإملاءات. وفي لبنان، دعمت الحكومة ومؤسسات الدولة بعد الحرب الأخيرة، بدلًا من تمجيد منطق السلاح الخارج عن الشرعية. وفي القمة العربية، لعب الوفد العراقي دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر، ورفض تسييس الملفات الخلافية.
وفي اليمن، استضافت بغداد الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وسمحت لخطابها أن يصدح من قلب العاصمة، في تحوّل واضح عن توازنات كانت تميل سابقاً للضبابية أو الحياد السلبي.
لماذا يجب أن يصغي الغرب؟
لأن العراق ليس مجرد "مشكلة أمنية" أو "ساحة نفوذ" كما اعتاد أن يُنظر إليه، بل بات يمتلك فرصة فعلية ليكون دولة توازن في محيط مضطرب.
الاستمرار في تجاهل هذا التحول، أو التعامل معه بمنطق الريبة أو الوصاية، سيعيد إنتاج الفشل نفسه الذي طبع العلاقات الغربية بالعراق لعقود. لكن بالمقابل، فإن بناء شراكة واقعية—قائمة على دعم المؤسسات، لا الأشخاص—قد يمنح العراق القوة الكافية للتحرر الكامل من أسر الجماعات والمشاريع العابرة للحدود.
الغرب، إن أراد شريكاً مستقراً في الإقليم، لن يجد لحظة أنسب من هذه ليكون العراق تجربته الديمقراطية الأعلى في ترسيم الشرق الأوسط الجديد.
بغداد تبتعد عن طهران بهدوء، دون استفزاز، لكنها تفعل ذلك بإصرار. تعيد بناء شرعيتها الخارجية بخطاب عقلاني لا صدامي، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل العودة إلى مربعات التبعية.
هذه لحظة عراقية بامتياز، وعلى الغرب أن يصغي جيداً. فالعراق لم يعد ساحة متروكة أو دولة مشاع، بل بلد يستخلص دروس ماضيه ويتقدّم بثقة نحو دور متوازن يعيد ترتيب الميدان الإقليمي بعيداً عن الاصطفاف الأعمى والخطابات الثأرية.
وإذا أُعطيت بغداد فرصة حقيقية، فقد تستعيد مكانتها كدولة مركزية تقود ولا تُقاد، توازن ولا تنجرّ. لكنها تحتاج أن تُعامل كرأس لا كذيل، وكشريك لا كملحق، وأن يُنظر إليها كمرتكز محتمل في منظومة الاقتصاد العالمي الجديد، لا كدولة هامشية خاضعة للابتزاز الذي أنهكها لنصف قرن.

 المنطقة الخضراء
المنطقة الخضراء