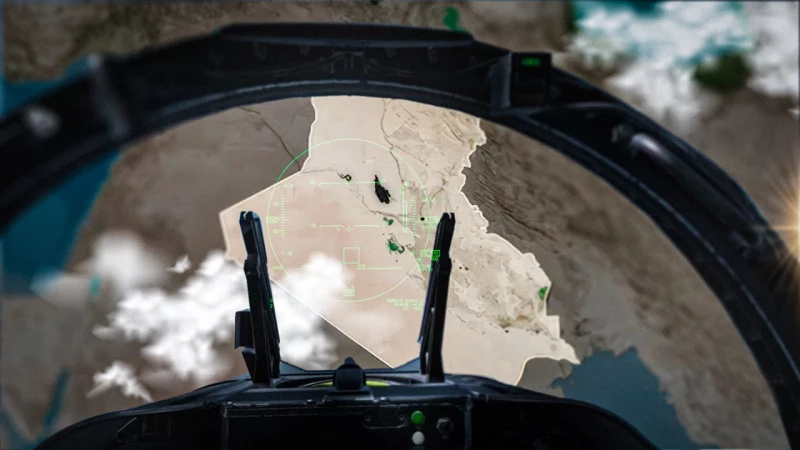طيلة يومين كاملين كانت آثار الموت بادية على وجهه، يقف بانكسار في مركز سرادق العزاء بملامح متجهمة. هذا شقيق صديقي، وهو أكثر إخوته حزناً على أبيه الذي انزلق إلى قبره فجأة، دون تذاكر أو أمراض مستعصية. ولكم أكبرت فيه هذا الحزن المفقود في زمن (الستوري) والقبور المرصعة باللايكات، وكانت ذاكرتي ستحتفظ بهذه السحنة الكئيبة الاستثنائية لولا دخول محافظ البصرة فجأة، وانقلاب كل شيء.
أهلاً شيخ، أهلاً شيخ.. وتراكض الإخوة نحو الشيخ أسعد العيداني، هرج ومرج، والابتسامات شرعت تنزّ في الوجوه شيئاً فشيئاً. كاميرات هواتف المعزّين فتحت وبدأت بالتسجيل، حتى صاحبي المفجوع - شقيق صديقي - انكشفت أساريره، ولمحت فرحاً مضطرباً فيه مسحة افتخار شاغبت تقاسيم وجهه الحزينة. قلت في نفسي: إنها السلطة بأوسع معانيها إذن، تتحكمُ في معنى حياتنا وموتنا والخط الخفي الفاصل بينهما".
لا يفارقني مشهد العزاء هذا، صرت أتذكره كلما رأيت مسؤولاً يشارك الناس أتراحهم ويهدد أحزانهم الوجودية بالإزالة، وأتساءل: لماذا تختفي الاعتراضات على الساسة والمسؤولين التنفيذيين حينما يحلّون بين الناس، فتذوب كلمات الإدانة فجأة وتُلتقط السيلفيات؟ وكأن معجمنا السوسيوسياسي معجم سحري تبتلع فيه الكلمات كلمات أخرى، مثلما تبتلع كلمة الشيخ كلمة المحافظ، ومثلما تبتلع كلمة الشيعي والسني كلمة المواطن، فيُختصرُ المعجم وتُختصرُ الحياة.
تبدو مدينة مثل البصرة مليئة بالشكوك، بسبب الفوارق الواضحة بين كيانها الجغرافي والاقتصادي ومضمونها الوجداني كقيمة وسلوك ونظام في وقتها الراهن. فلا يتفاجأ البصراوي بحدوث نزاع عشائري مسلح في قلب المدينة، في العشار أو الجزائر، لأسباب بعضها تافهة، كما لن يصدمه جوهر ما فعله العيداني حين غرق طفلان في القرنة؛ الأمر الذي ولّد أزمة بين ذويهم والشركة المنفذة لمشروع البنى التحتية، والتي دفعت المحافظ لأن يتدخل لا بصفته محافظاً بل شيخاً، إذ حكم بلغة العشيرة بدلاً من لغة القانون والدولة. إنها أمور تحدث كثيراً، فالشيخ سبق أن دخل من باب العشيرة لحل نزاع بين عشيرتي البطوط والحمادنة بينما كانت الدولة تشاهد من النافذة وعلى استحياء.
لكن أخطاء المسؤولين في العراق جزء أصيل من مكاسبهم السياسية والشعبية، فالمنطق الجمعي ليس بالضرورة منطقياً. ولو حدقنا بشيء من الإنصاف لأبطالنا السياسيين في تاريخنا الحديث، فقد لا نجدهم أبطالاً، بل متصرّفين ومزوّرين لقيم السياسة بمعونة اللغة التي تنساب في الأفواه وتخمّر الأفكار في العقول المفتونة بقول "نعم". وما من إنسان يستطيع العيش خارج الجماعة إلا إذا كان إلهاً أو وحشاً، كما أخبرنا أرسطو، وهذه كارثة الكوارث.
لكن مع ذلك كله، وبينما كنت بانتظار المتبقي من صاحب محل أسواق يبحث في الجرار عن خردة، أحالني صوت صبي"بصراوي" إلى نوع خاص من المقاومة، نوع فريد يكون فيه الفعل الفردي بمثابة فعل سياسي غير منظور، ليس معلباً بعد داخل إطار وعناوين تقول لك إن له أهدافاً ومآرب؛ هناك أشياء تؤجل الكارثة أو الإحساس بها. فماذا قال الصبي، عبر اللغة المفقودة والمنسية؟ لم يفعل هذا الطفل المعجزات، كل الأمر أنه قال "عمو" بنبرة بريئة تنتمي الانتماء كله للطفولة المغيّبة، وبدأ يسأل بلغة الصغار التي ابتلعتها لغة الكبار. هذا ما سرّني وأحزنني، العادي الذي صار عجيباً. فأطفال المدينة يستعملون لغة هرِمة عادة، لكن الصبي - الطفل - يستخدم معجماً خاصاً: "عمو من فضلك أريد جاي أحمد" بنبرة فيها حياد ومسافة.
بالمناسبة، كنتُ حينها أعمل مدرساً لمادة العلوم في مدرسة أهلية، أدرّس الصف الثاني، خمسة شعب ممتلئة بالزي الموحد. التدريس مهنة شاقة أعترف، لا سيما وأنت تدرّس أطفالاً. الأمر يشبه النظر إلى لعبة لتشكيل المصائر، يكبرون أمامك ومن خلالك وتتبادل معهم الكلمات، وقد تعرف معجمهم أكثر من أمهاتهم وآبائهم. وكم كنتُ أعجب من اللغة التي يستعملها هؤلاء الأطفال، يكثر أن أحدهم ينادي زميله أثناء الفرصة بـ "ضلعي" أو "حبيبي" بصوت غليظ ومُفتعل. بل الأمر يتعدى ذلك للحديث عن الموت بشكل خالٍ من التعجب، فلم يعد الموتُ عجباً كما كانت تردد الألسن في زمان آخر.
حدث مرة أن أحد الطلاب الأطفال تابعني عبر (إنستجرام)، فدفعني الفضول لتصفح حسابه. لم يبدُ طفلاً أبداً، اللقطات مأخوذة بحركات وملامح تناسب الكبار، والأغاني التي اختارها لتغليف صوره صوتياً كانت ثقيلة لحد كبير، فيها تجارب عاطفية عميقة ومجسّمة وأبيات شعرية حسية غارقة في بحر الرغبات الجنسية، وأخرى تتغنى بالعشائر وسلطة القوة والقدرة على تدمير الخصوم. إنه حساب طفل في الثاني المتوسط، فيا للفزع.
ولكم أخافني هؤلاء الصغار مراراً. أستاذ يخاف من طلابه، إنها أمور تحدث صدقوني. يقين يقر بداخلي أن الكلمات تنمو في الجوف لتكون فعلاً أو مجموعة أفعال، وأن كلمة مسدس لها دويّ مهما بدت وديعة على السطور، وأن التغني بالعادات العشائرية قد يحمل بين طياته جرائم غسل العار والفصلية والدكة والفصول الجائرة.
لكن مع ذلك كله، وأنا أتذكر في هذه اللحظة عالم الاجتماع بيير بورديو، ألا يحق لي أن أسأل كيف يمكن أن تتمايز كلمات الوجاهات السياسية عن كلمات عامة الشعب، فتكون مكتنزة بالعنف اللغوي الرمزي، مهما بدت محايدة وبريئة وتعبيراً خالصاً عن الهوية؟ والآن، هل تتذكرون "إحنه البصرة"؟
"إحنه البصرة" كان شعاراً لافتاً لتحالف تصميم الذي يشكل محافظ البصرة أسعد العيداني ركنه الأساس، وكانت هذه الجملة المكتوبة على لافتات المرشحين للانتخابات المحلية الأخيرة بمثابة بديل استثنائي عن البرنامج الانتخابي. واستطاع العيداني بفضل ترسيخها من الفوز بالانتخابات على كل القوى الفاعلة المنافسة في البصرة والتي غاب عنها التيار الصدري، إذ حرص مؤيدو العيداني في برامج التواصل على إظهار"الشيخ" باعتباره حلم الوصول إلى بصرة نقية "خالصة الأصول"، خالية من أبناء المحافظات الأخرى الذين هرعوا للبصرة بعد 2003 بحكم فاعليتها الاقتصادية وتوفر فرص العمل بسبب واقعها النفطي ووجود الشركات الأجنبية، مما غيّر من طبيعة الوضع الديموغرافي للمدينة بالإضافة لتغيير جانب كبير من العادات الاجتماعية وضخ أنواع أخرى من العنف يراها عدد من البصريين مرتبطة بالهجرة الداخلية. الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً في التنافس على زعامة المحافظة الأغنى في العراق، وهذا ما يوضحه شعار تصميم "إحنه البصرة"، والذي يأخذ قيمته من دور قائله، العيداني صاحب السلطة الأعلى محلياً، ما ترك مناخ الانتخابات عرضة لتساقط الكلمات المرة بين ساكني المحافظة مختلفي الأصول، لدرجة أن أبسط تصرف سلبي نراه في الشارع صار يُنسب مباشرة إلى "اللفو"، في إشارة إلى الغرباء الذين حلّوا في المدينة وأزاحوا مدنيتها، وهو توصيف مبالغ فيه بل كذبة، لكنها تجاوزت معنى الصدق عند كثيرين. وبقليل من التأمل في الأحاديث الجانبية في المقاهي ومع سائقي التكسي، ستجد أن اللغة قد تحولت إلى حقل ألغام وساحة للصراع مشحونة بالعنف لدوافع تتعلق بالسلطة التي تأخذ فاعليتها من إشاعة هذه الروح في الميديا، وتنجح كل مرة في تحييد أهمية إظهار البرامج الانتخابية وخطط الخدمات التي ينبغي أن تُقدّم للمواطن، المواطن الذي ينطلي عليه خداع الأبجدية حتى يتحول هو نفسه إلى جملة حائرة.