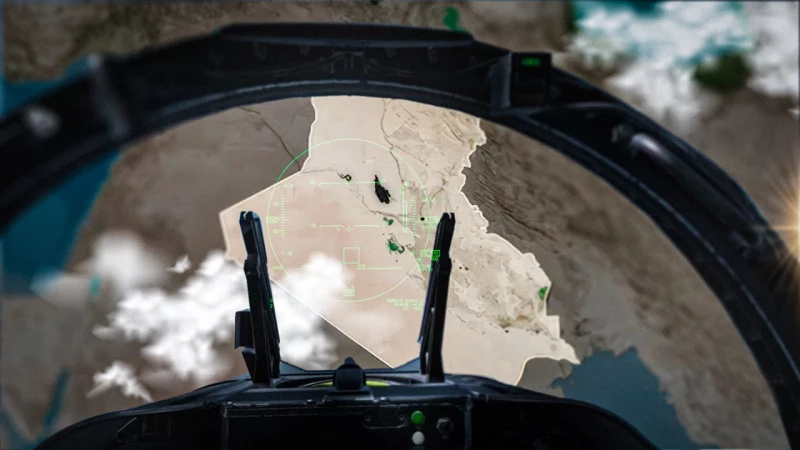ربما كان مصطفى كمال أتاتورك هو الشخصية الأكثر تأثيراً على طموحات الكرد القومية في بدايات القرن العشرين، خصوصاً مع إلغاء معاهدة سيفر (1920)التي اعترفت بالحقوق القومية للشعوب الخاضعة للدولة العثمانية، وتم استبدالها بمعاهدة لوزان (1923) التي اعترفت بالحدود التركية كما كانت بعد حرب الاستقلال التركية (1919-1923)، وقمعت ضمناً مطالب الكرد في كردستان الشمالية [جنوبي شرق تركيا] بالاستقلال.
ولكن هذا "العدو" يقدّم لنا درساً، في منطقة أخرى من التاريخ، فمن الواضح بالنسبة للباحثين أنه لولا دعم السوفيات لأتاتورك ما كان له أن ينتصر في حرب الاستقلال ضد الاحتلال اليوناني والبريطاني والإيطالي وحلفائهم. لقدّ قدّم ستالين، زعيم الاتحاد السوفيتي في وقتها، مساعدات عسكرية ومالية ودبلوماسية ثمينة لأتاتورك، من وحي وقوفه مع الشعوب التي "تحارب الإمبريالية الغربية".
لكن أتاتورك لاحقاً انقلب على السوفيات، وولى وجهه شطر الغرب، لأنه فهم أن السوفيات يسعون للتمدّد الأيديولوجي، بالإضافة إلى اختلاف التوجهات معهم، فأتاتورك كان قومياً علمانياً ولم يكن شيوعياً، وكان مهتماً بالالتحاق بحركة التحديث الغربية، وتوفير حلفاء أقوياء في عالم بات مقسماً إلى معسكرين.
كان تغيير الدفّة، في لحظة حاسمة من التاريخ، أمراً جسيم الأهمية، وهو ما أنتج تركيا الحديثة التي نعرفها اليوم.
الشيء نفسه يتكرّر لاحقاً، مع "عدو" آخر، هو ديفيد بن غوريون، فربما لا يعرف البعض أن بريطانيا، صاحبة وعد بلفور الشهير، كانت قد تخلّت عملياً في العام 1947 عن هذا الوعد، ونفضت يدها من الملف الفلسطيني والصراع الناشب فيها بين العرب واليهود، وسلّمته الى الأمم المتحدة، وسبق ذلك مقدمات أهمها مضمون الكتاب الابيض الثالث (1939) الذي أقرّ صراحة بفكرة إنشاء دولة فلسطينية يعيش فيها اليهود، ولا يذكر الكتاب أي شيء عن دولة يهودية. الأمر الذي دفع اليهود إلى الانتفاض على السلطة البريطانية والقيام بأعمال "مقاومة" مسلّحة.
من الذي أنقذ "الدولة الإسرائيلية" الناشئة؟ إنه الدعم السوفيتي، وخصوصاً في المجال العسكري، والذي لولاه لانهزم الإسرائيلون أمام الجيوش العربية في حرب 1948.
ولكن، كما في مثال أتاتورك، بعد الانتهاء من الحرب، وجّه بن غوريون وجهه نحو الغرب، وألقى السوفيت وراء ظهره. لأنه فهم أن حركة التاريخ مع الليبرالية الرأسمالية والحداثة الغربية، وكان رهانه ناجحاً.
وإذا غادرنا الأمثلة من العصر الحديث وقفزنا إلى الخلف، إلى 1400 سنة ماضية، سنقرأ عن عمرو بن العاص، الذي يكرهه الشيعة، ويعتبرونه عدواً. سنتعلم أيضاً من هذا "العدو" درساً مفيداً.
كان عمرو بن العاص والياً على مصر، ولكن الخليفة عثمان بن عفان في وقتها انزعج من قلة الموارد من خراج مصر، فاستبدل بن العاص بأخيه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرح. وعاد عمرو بن العاص إلى المدينة. وفي الموسم اللاحق لخراج مصر، جاء الخراج وقد تضاعف، فسرّ الخليفة أيما سرور، وهنا نظر إلى عمرو بن العاص وقال له معاتباً: يا عمرو هل تعلم أن تلك اللقاح درَّت بعدك؟ [أي أن خراج مصر ازداد بعد عزلك عن ولايتها] فقال عمرو: إن فصالها هلكت، وفي رواية: ولكنكم أضررتم بالفصيل. [أي: نعم زاد الخراج ولكنكم جعلتم المصريين جوعى ولن يقدروا في الموسم اللاحق على العمل وانتاج نفس المقدار من الخراج].
ولعلها حكمة بليغة يمكن أن يستفيد منها أي حاكم في أي عصر، فمهما بلغ بك الطمع لأخذ المال العام دون وجه حق، حاذر أن تجعل الناس في ضنك وفاقة، فإنهم سيثورون عليك.
نتقدم في الزمن بضعة سنوات، لنطالع كلام "عدو" آخر. فخلال تقدم الإمام الحسين باتجاه الكوفة في العراق، وصل عبيد الله بن زياد متنكراً إلى الكوفة، وحياه الناس ظناً منهم أنه الحسين، حتى دخل قصر الكوفة، وهنا خاطب وإليها النعمان بن بشير غاضباً: حصّنت قصرك وتركت مصرك. أي إنك انشغلت بتحصين المنطقة الخضراء الخاصّة بالكوفة، وأهملت الشعب خارج أسوارها، وهي حكمة بليغة من فم عدو، تستحق الانتباه والتأمل في كلّ عصر وأوان.