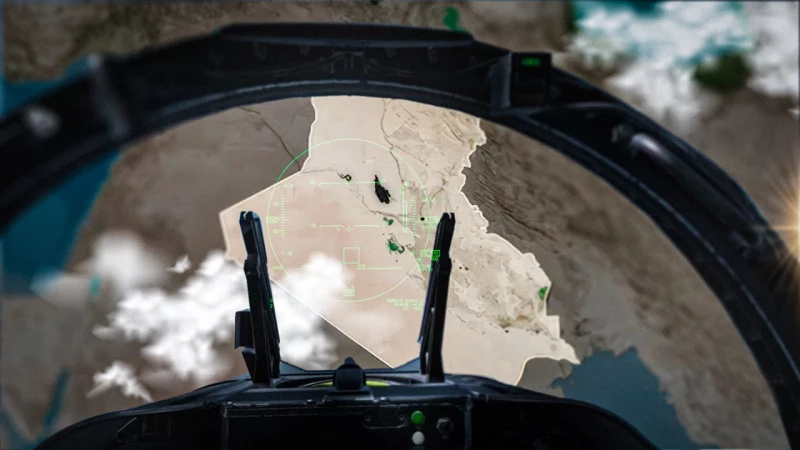بات الذكاء الاصطناعي أشبه بـ "الحكيم الرقمي" الذي يتسلل إلى كافة زوايا حياتنا المعاصرة، لكنه في السياسة، وخاصةً في الانتخابات لم يعد مجرد تقنية صامتة، بل أصبح لاعباً نشطاً. في عالم يتحول بخطى متسارعة نحو الاعتماد على الخوارزميات والأدوات الرقمية. شهدت الانتخابات الأميركية الأخيرة بروز الذكاء الاصطناعي كقوة فاعلة ومؤثرة، تلاعبت بنفوس الناخبين، وامتد تأثيرها عميقاً داخل المشهد الانتخابي، مُحدثة تحولات غير مسبوقة.
كثيرةٌ هي التساؤلات التي تثار حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على التحكم في الرأي العام، بل وحتى إعادة صياغة قناعات الناخبين على نحو يتماشى مع رؤى وخطط المرشحين. عندما نتأمل في هذا الواقع، نجد أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مساعدة في الحملة الانتخابية، بل هو بمثابة "الراصد" الذي لا يغفل عن نبض الناخبين. فهو يقبع خلف الشاشات، يرصد تعابير الوجوه، ويحلل الآراء المتناثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ليخلق صورة شاملة عن توجهات الناخبين وميولهم، وليوجه الحملات بطريقة لم تشهدها أميركا من قبل.
لكنني أرى أن الذكاء الاصطناعي في الانتخابات لا يجب أن يُنظر إليه من زاوية التكنولوجيا الباردة فقط؛ بل علينا العودة إلى الوراء، إلى زمن كانت فيه السياسة مبنيةً على الخطاب المباشر والتواصل مع الناس عبر الحشود والمنصات العامة. في ذلك الوقت، كان الخطاب السياسي يعتمد على الكلمة القوية والحضور الشخصي، على سبيل المثال خطب إبراهام لينكولن، التي جذبت القلوب والعقول دون أن تحتاج لأي وساطة تكنولوجية. أمّا الآن، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي هو الوسيط، الذي يعمل كحاجز يفصل المرشح عن الناخبين، ويحوّل التواصل إلى تفاعل رقمي. هل يجعل هذا الذكاء الاصطناعي الانتخابات أكثر "ذكاءً" أم يخلق نوعاً من الفجوة العاطفية بين الناخبين ومرشحيهم؟
لقد برز هذا التحول في الانتخابات الأميركية الأخيرة بشكل واضح، حيث ظهر الذكاء الاصطناعي كمحرك خفي وراء رسائل الحملات الانتخابية ووسائل إقناعها. أصبح دور الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحليل الأرقام الباردة، بل تطور ليشمل تصميم استراتيجيات معقدة تعتمد على فحص تفصيلي لمشاعر الناخبين وتوقع ردود أفعالهم. هنا تكمن خطورته، حيث أنه قادر على تحويل الحقائق إلى صورة مشوهة تستغل المشاعر، وتعيد تشكيل القناعات بأساليب متقنة يصعب على الفرد العادي مقاومتها أو حتى إدراكها.
هذا التحول يشكل سؤالاً ملحّاً: إلى أي مدى يمكننا الوثوق في الانتخابات إذا كانت تدار بواسطة خوارزميات لا تفرق بين الحقيقة والتلاعب؟
لقد أصبحت الحملات الانتخابية أشبه بمسرح كبير، حيث تتسابق الشخصيات السياسية للظهور أمام الجمهور بوجوه لامعة وأصوات مدروسة، ولكن خلف هذا العرض البراق يقف الذكاء الاصطناعي، المخرج الخفي الذي يُسيّر خيوط اللعبة في صمت. ففي الانتخابات الأميركية الأخيرة، لم يكن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل كان أشبه بعقل مفكر يتغلغل في بنية الحملة، يمتص البيانات ويُعيد ترتيبها بأسلوب دقيق يستهدف كل ناخب وكأنّه يعزف على أوتار ذهنية ونفسية خفية.
وفي عالم تتسارع فيه المعلومات ويفيض ببيانات الناخبين، أتى الذكاء الاصطناعي ليحوّل البيانات الهائلة إلى أفكار واستراتيجيات متكاملة تُعدّ بدقة شديدة وتُرسل إلى الجمهور بأسلوب مصمم خصيصا لملامسة أعمق مشاعرهم. لقد سمح الذكاء الاصطناعي بفهم أنماط سلوك الناخبين وتوقع ردود أفعالهم، وبذلك تحوّل إلى أداة فريدة في يد السياسيين، تمكنهم من بناء رسائل تصل إلى الناخبين برسالة مخصصة تُخاطب اهتماماتهم، مخاوفهم، وحتى طموحاتهم الفردية.
وهنا، يمكننا أن نتأمل كيف يعكف الذكاء الاصطناعي على فرز وتحليل معلومات لا حصر لها، مثل تفاعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنماط البحث الشخصي، وحتى التعليقات التي قد تبدو عابرة. في الانتخابات الأميركية، مثّل الذكاء الاصطناعي قدرة غير مسبوقة على الاستهداف الموجه، فبات يعرف تماماً ما الذي يحرك ناخباً في ولاية معينة، وما الذي يجعل ناخباً آخر متردداً، وكيفية الوصول إليهما عبر رسائل مختلفة تتنوع في المضمون ولكنها موحدة في الهدف.
هذا التوظيف ليس عفوياً أو بمحض صدفة؛ بل هو نتيجة لعمل ممنهج يقوم على دراسات نفسية واجتماعية متعمقة، لتصميم رسائل تستند إلى رغبات الجمهور وتصوراته دون أن يشعر هو نفسه أنه يخضع لعملية إقناع مخطط لها بعناية. وهنا تكمن مهارة الذكاء الاصطناعي: فهو لا يقفز على سطح الآراء فقط، بل يغوص في خبايا التفكير الفردي، ويصوغ رؤى تلامس قلب كل ناخب على حدة، محققاً بذلك أقصى درجات التأثير والإقناع.
في الحقيقة، قد يصل الأمر إلى حد "تفكيك" شخصية الناخبين رقمياً، وتصنيفهم وفق معايير دقيقة تجعل من السهل على الحملات صياغة خطاب يلائم كل فئة. لم تعد الرسائل الانتخابية موجهة لجماهير واسعة بطريقة موحدة، بل باتت تُحاك بشكل يلامس خصوصيات كل ناخب، وبهذا تتجاوز الحملات الانتخابية حدود الخطاب التقليدي، لتصل إلى مرحلة يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي بما يسمى "التلاعب العاطفي"، حيث يُستخدم الفهم الرقمي الدقيق لتحريك مشاعر الناخبين وتهيئتهم للاستجابة كما يريد المرشحون.
والسؤال الذي يطرح هنا: هل باتت الديمقراطية لعبة تُدار بخوارزميات تصنع الولاءات وتؤثر في التصويت؟
حينما نتحدث عن استغلال دونالد ترامب للذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأميركية، فإننا ندخل في عالم متشابك من الاستراتيجيات الذكية والتحليلات العميقة التي تقترب من فن "التلاعب النفسي". لقد أدرك ترامب وفريقه الانتخابي منذ البداية أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحليل، بل هو أشبه بـ"منجم ذهب" يستخرج منه بيانات الناخبين ويحوّلها إلى سلاح سياسي بالغ الدقة. وهكذا، تبنى ترامب هذه التقنية بقوة، محاولًا أن يجعلها عصب حملته، في أسلوب تفوّق به على خصومه.
استخدم فريق ترامب أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوكيات الفردية للناخبين، مستغلين كل تفاعل رقمي، وكل مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنهم يرسمون "بروفايل" دقيقاً لكل ناخب.
يقول أحد أعضاء فريق حملة ترامب: "لم يكن هدفنا مجرد جمع بيانات، بل فهم دوافع الناخبين على مستوى عميق، بحيث نصل إلى عقولهم قبل أصواتهم". هذه التصريحات تعكس استراتيجية متقدمة في التفكير؛ تحوّل فيه الذكاء الاصطناعي إلى مرشد خفي يقود خطط الحملة، ويوجهها نحو كل فئة من الناخبين بأسلوب خاص يناسب تطلعاتهم أو مخاوفهم.
ومن خلال الذكاء الاصطناعي، تمكن ترامب من توجيه إعلاناته ورسائله بطريقة موجهة ودقيقة، مستفيداً من تقنيات "التعلم الآليMachine Learning" لتحليل استجابات الناخبين وضبط الرسائل الانتخابية لتلائم أعمق اهتماماتهم. ويضيف أحد مستشاري ترامب في هذا السياق: "لم نكن نرسل رسالة عامة، بل كنا نرسل رسالة شخصية إلى كل ناخب، لقد صنعنا حواراً فردياً مع كل واحد منهم". هذا التصريح يبرز بوضوح كيف حوّل ترامب الذكاء الاصطناعي إلى قوة دفع شخصي، حيث لم يكن مجرد خطاب سياسي بل حواراً شخصياً مع كل ناخب، حتى يشعر وكأن الرسالة موجهة إليه وحده.
إحدى الأدوات التي اعتمد عليها فريق ترامب بشكل ملحوظ كانت تقنية "تحليل المشاعر (Sentiment Analysis)"، والتي تقوم بتفكيك النصوص التي يكتبها الناس على وسائل التواصل، وتصنيفها بناء على الانفعالات والمشاعر التي تعكسها. من خلال هذه التقنية، استطاع فريق ترامب تحديد الموضوعات التي تثير الغضب أو الحماسة لدى الناخبين، ومن ثم توجيه الرسائل التي تتوافق مع هذه المشاعر. في هذا السياق، صرح أحد أفراد الفريق قائلاً: "كنا نعرف ما الذي يغضب الناس، ونعمل على تأجيجه، السياسة ليست مجرد حوار، بل هي فن الوصول إلى العواطف".
إن هذا الاستغلال الذكي للذكاء الاصطناعي، يخلق التساؤل: هل أصبح الناخب مجرد هدف رقمي تلاحقه الخوارزميات؟ أم أن هذه التقنية التي تبدو براقة وساحرة، تحمل في طياتها خطراً على نزاهة الانتخابات وحريّة الإرادة؟.
فلا يمكن تجاهل التحديات والأخطار الكبيرة التي ترافق استغلال الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية. فهذا الاستخدام المكثف للخوارزميات والتحليل العاطفي، رغم فعاليته، يفتح الباب أمام انتشار الأخبار المضللة واستغلال العواطف الشعبية، مما يهدد نزاهة الانتخابات. كيف يمكن أن نثق في عملية ديمقراطية تتشكل ملامحها تحت ضوء خافت من خوارزميات لا نرى وجهها؟ إن تضليل الناخبين وتوجيههم بأساليب لا واعية يطرح أسئلة عميقة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودوره في صناعة واقع سياسي يبدو أحياناً بعيداً عن الحقيقة.
وفي المستقبل، قد يصبح الذكاء الاصطناعي العمود الفقري للحملات الانتخابية، حيث يتمتع بقدرة فائقة على تحليل الجمهور وصياغة الرسائل الفردية بأسلوب مثير وفعال. لكن، ينبغي النظر بجدية إلى ضبط هذا الاستخدام ضمن إطار يضمن الشفافية وحماية الخصوصية. هل نحن على مشارف عهد تتفوق فيه الخوارزميات على إرادة الناخبين، أم أن الديمقراطية قادرة على التأقلم وحماية نفسها من هذا التسلل التقني؟.
في الختام، يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح ركناً أساسياً من أركان الحملات الانتخابية المعاصرة، وأداة ذات تأثير عميق في تشكيل توجهات الناخبين وصياغة الواقع السياسي. لقد منحت هذه التقنية المرشحين قوة هائلة لقراءة الجمهور وتوجيه الرسائل بدقة لم نشهدها من قبل، محوّلةً العملية الانتخابية إلى مشهد تتشابك فيه الخوارزميات مع الخطابات التقليدية في لعبة تبدو ساحرة، لكنها تحمل في طياتها الكثير من الأسئلة.
هل نحن أمام مستقبل تتلاشى فيه الحواجز بين الحقيقة والتلاعب؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح خادماً مخلصاً للديمقراطية دون أن يلوثها بأغراض أخرى؟ أسئلة حتماً سترافقنا في ظل هذا التطور المتسارع، حيث يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد التوازن بين استثمار الذكاء الاصطناعي في إثراء العملية الانتخابية وحماية نزاهتها.

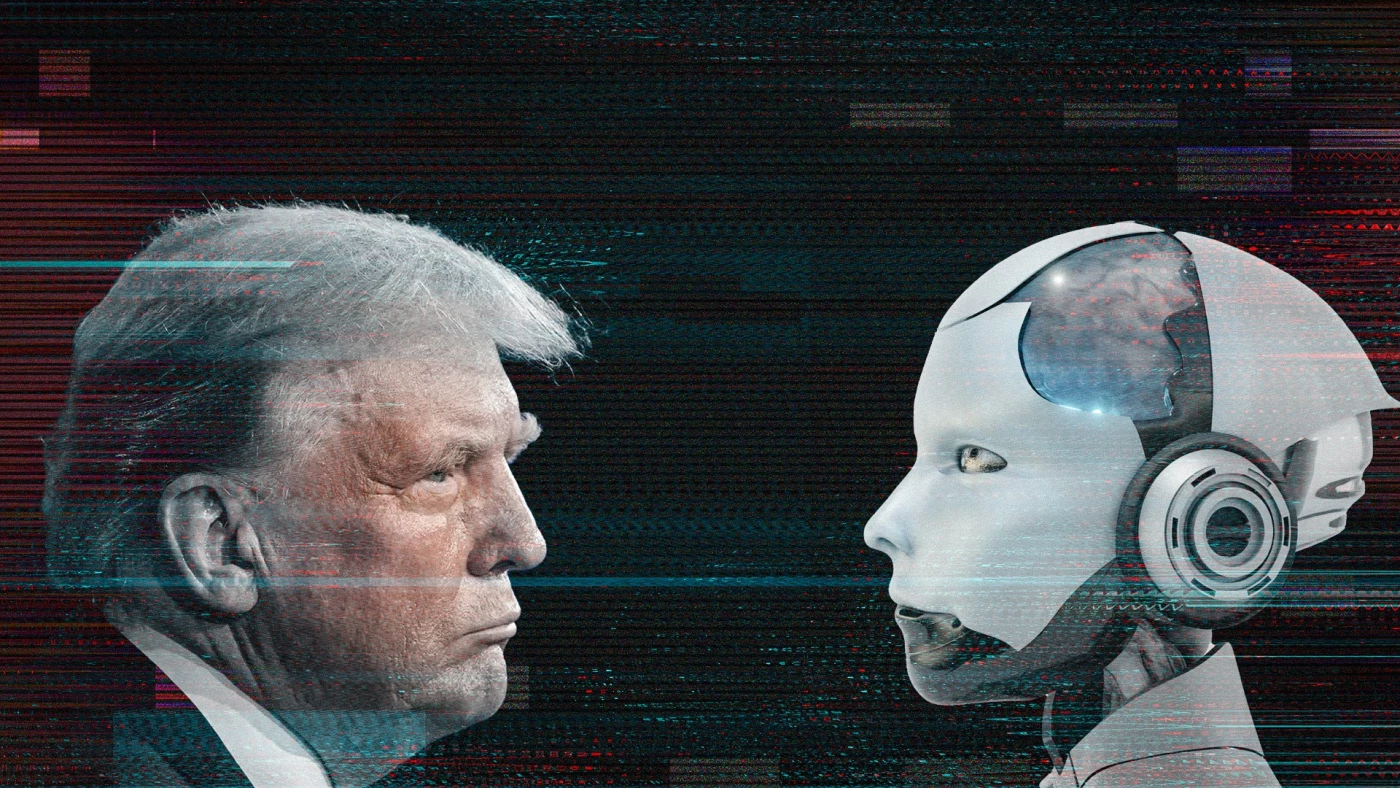 تعبيرية
تعبيرية