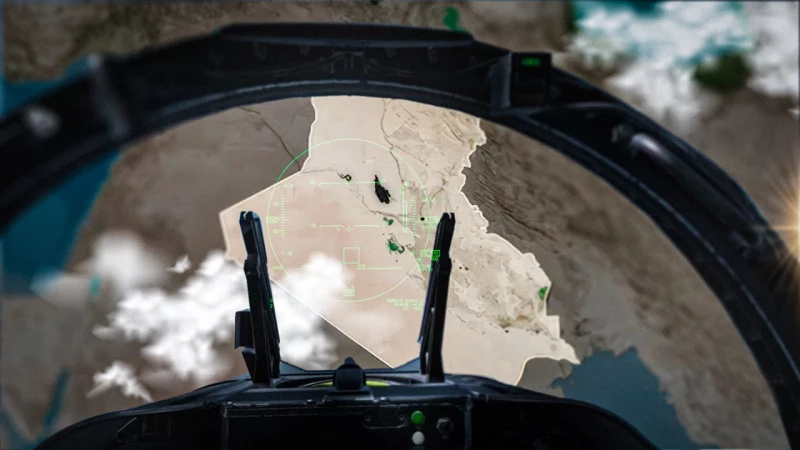مؤخراً، كنت في زيارة إلى دمشق أو كما يسميها أهلها "الشام"، وقد مرّ على سقوط حكم الأسد عام، كانت مختلفة، نشاهد بطبيعة الحال جانباً من هذا الاختلاف عبر القنوات ووسائل الإعلام، أما الجانب الآخر فمرتبط بالكينونة، لا يخرج للعلن بل يُستشعر في المكان هناك.
تفاصيل دقيقة يلحظها من عاش سوريا قبل اندلاع الثورة وخلالها، وجزء كبير منها كان قد غاب خلال رحلة سابقة كنت قد أجريتها صيف 2023.
كانت الصورة مغايرة، لقد كانت ملوّنة، وكأن جسداً نفذت له الروح عقب اختناق، بدت الشام حيوية أكثر، مكتظة أكثر، ومرتاحة أكثر. كان الخوف منكفئاً، الصمت متلاشياً، فالأحاديث تدور بصوت أعلى. لقد بدت مظاهر سكينة على الناس والأحياء والأزقة والشوارع وحتى المِحال. كانوا من صادفتهم مبتسمين فرحين بما آلو إليه، أتحدث عن دمشق، وكان الياسمين مزهراً بكثرة في كل مكان.
وتجريداً من أي نوازع عنصرية أو طائفية، غدت بعض المعالم أنضف (مادياً) مما كانت عليه قبل سنتين مثل: سوق الحميدية التاريخي والجامع الأموي الكبير خلفه ومطار العاصمة.
شهدتُ وضعاً هادئاً، وآمناً.
لم تسنح لي الفرصة صعود قاسيون وإلقاء نظرة سماوية على المدينة، لا تزال الطرق إلى القمّة مغلقة "لضرورات أمنية". فكل ما ذكرته لا ينفي أن سوريا لا تزال منهكة، فما شهدته ليس بهيّّن، وهي تحتاج لسنين إن لم يكن لعقود من أجل التعافي من مفرزات الحرب الطويلة.
هواجس لَبنَنَة سوريا أو تكرار التجربة العراقية تهيمن في الأفق، وتختلج جزءاً لا يستهان به من السوريين، إذ أخبرني عديد ممن التقيتهم هناك بأنه "يريدون تحويلنا إلى عراق ثانية، نحن لا نريد تكرار التجربة العراقية، تعبنا الحرب والقتال والدمار لـ14 عاماً، ولا نقوى على المزيد. نريد أن نبني بلدنا ونحيا في سلام".
هم على حق، فهناك عوامل كثيرة يتشارك فيها البلدان، تنسخ الوقائع بينهما، وقد تدفع بسوريا إلى نفس المسار الذي آلت الظروف العراق إليه بعد عام 2003 (النزاع الطائفي)، أولها أن سوريا أرض كبيرة، وفيرة الثروات والخيرات، وتحمل تضاريس منوعة وشعباً متعدّد الأعراق والقوميات والأديان، جميعهم عريقون (أصحاب أرض)، أغلبيات وأقليات عانت الظلم والفقر والقهر والاجحاف والتهميش بصور مختلفة، كل واحدة منها تبحث الآن عن الإنصاف والتعويض والقسط في الحقوق والحريات، وحياة عادلة كريمة، وواقع يرفع حيف الماضي عنها ويضمن عدم تكراره. ذلك ينعكس في تنوّع مطالب الكورد في شمال شرق البلاد والعلويين على الجانب الساحلي الغربي منه والدروز في الجنوب، وعدم وصولهم لسبيل مع الحكومة الجديدة في دمشق حتى الآن. وما يزيد الوضع خطورة هو التنافس الدولي للولوج في سوريا الجديدة، واختلاف خطط القوى الفاعلة على الأرض بشأنها وإمكانية توظيفها هذا التناقض الداخلي في تنفيذ تلك المخططات.
لكن بالمقال، هناك تباينات جليّة تجعل الحالة السورية مغايرة للحالة العراقية، وهي بمثابة محركات لبناء تجربة جديدة مختلفة كل الاختلاف عمّا وقع في العراق، أبرزها:
لقد جسّد العراق التجربة الأولى للتغير في المنطقة، تجربة أفرزت نتائج إيجابية وسلبية، تخبر المحيط (في المستوى السياسي - المحلي والدولي، والمستوى الشعبي) الكثير. ويمكن لسوريا الاستفادة من الدروس التي قدمها العراق في رحلة التغيير (اتباع المزايا والإيجابيات وتلافي العيوب والسلبيات).
وثمّة فرق جوهري بين التجربتين، هو أن إسقاط النظام في العراق كان على يد قوة خارجية أجنبية (الولايات المتحدة)، أما في سوريا فوقع على يد السوريين أنفسهم (المعارضة)عقب ثورة خاضوها لسنوات..
لقد دخلت الولايات المتحدة العراق حاملة معها نموذجاً مصمّماً جاهزاً وضعته قيد التنفيذ بدون أخذ كثير من الضرورات والوقائع الداخلية للبلد بعين الاعتبار، ضربت وهدمت بشكل عشوائي، أحرقت رقعاً وألغت مؤسسات. عمدت اختلاق فوضى اعتبرتها خلاقة، وأقامت نظاماً جديداً يستند إلى التقسيمات الطائفية. أما في سوريا حدث التغيير بتنظيم وهدوء أكبر بعد دخول قوات المعارضة المسلحة العاصمة عبر عملية عسكرية امتدت من الشمال إلى الجنوب بالتدريج. أُعلِن سقوط النظام، دخلت المعارضة العاصمة، واستلمت السلطة من النخبة المنهارة بأيام، دون مقاومة، دون هدم، دون استهداف للمؤسسات، ما حدث هو انتقال الإدارة من مجموعة إلى مجموعة جديدة، وهذا عامل رئيس في جعل التجربة مختلفة في سوريا، فيما تؤكد الحكومة بقيادة أحمد الشرع أنها تعمل على إنشاء نموذج جديد "يوافق طبيعة المجتمع السوري وأهله، ويضمن وحدة البلاد، العدالة ، وحماية الحقوق والحريات".
في العراق اندلعت الحرب الأهلية (الطائفية) بعد سقوط نظام صدام حسين، أما في سوريا سقط النظام بعد حرب داخلية دامت نحوعقد ونصف، طالت ويلاتها البشر والحجر، وتاركة السوريين منهكين وسط أزمات أغرقت البلاد. حقيقة، السوريون اليوم على اختلافهم وعلى اختلاف تطلعاتهم ومطالبهم توحدهم غاية مشتركة وهي "السلام"، وهذا بذاته سبب لإضعاف احتمال الدخول في حرب داخلية جديدة.
ويحضر العامل الدولي في المعادلة السورية بقوة، وهو أيضاً شهد تبدّلات يمكن أن تدفع لخلق نتيجة مختلفة للتغيير في سوريا، في مقدمتها "الوجود الإيراني"، و"الدور الأميركي".
لقد ساعد سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 بشكل كبير في تمدّد النفوذ الإيراني إلى العراق ومنه إلى سائر المنطقة، أما في سوريا وقع العكس تماماً، فقد أدى سقوط حكم بشار الأسد في 2024 إلى إنهاء الوجود الإيراني في البلد وحسر نفوذ طهران بالمنطقة أكثر. ولا يمكن إنكار أن إيران تجسد لاعباً رئيساً في رسم التفاعلات السياسية وتحريكها في المنطقة، وكان لها دور كبير في إدارة المشهد لصالح النظام السابق على طول سنوات النزاع، بالتالي إن أفول الحضور الإيراني داخل سوريا تبدّل مهمّ ستكون له نتائجه بالتأكيد على مسار سوريا الجديدة سواء بالسلب أو الإيجاب.
والفارق الأهم هو، توافق رغبة القوى الداعمة للتغيير في سوريا وعلى رأسها (الولايات المتحدة) ورغبة الداخل السوري في النهوض وتحقيق الأمن والاستقرار وبناء نظام معاصر يتوافق مع تطلعات السوريين ومتطلبات المرحلة الراهنة ويشكّل عامل سلام مستدام بالمنطقة. لقد تعلمت واشنطن من حربها على العراق الكثير، وهي تسعى لتلافي الأخطاء التي وقعت فيها هناك بسوريا، (تشجيع الفوضى) و(البناء على أساس التقسيم الطائفي)، ذلك معلن في الموقف الأميركي ويتوضح في تصريح توم باراك مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا بمقابلة أجراها مع صحيفة "ذي ناشيونال"، بأن "العراق مثال واضح على الأخطاء التي لا يجب أن تكررها الولايات المتحدة"، عادّاً أن "المشكلة في العراق وسوريا تكمن في إمكانية تحول المشهد إلى التقسيم وخلق جمهوريات فيدرالية يُمنح فيها الكورد حكماً ذاتياً، تماماً كما حدث في يوغوسلافيا"، وهو حذّر من "مخاطر التقسيم، وعدم الاتفاق على نموذج فيدرالي واحد".
أكد باراك أن "خلق فدراليات قد يستمر لفترة قصيرة جداً ثم يبدأ التقاتل".
ترغب واشنطن باستتباب أمن واستقرار مستدام في سوريا يضمنان وجوداً آمناً لها هناك، لذا تسعى لخلق التوافق بين الكورد في الشمال بالدرجة الأولى والحكومة بدمشق بأسرع وقت. وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، مؤخراً، أن "واشنطن مستعدة لدعم المحادثات الجارية بين قسد والحكومة السورية، بما في ذلك الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها دمشق"، حيث ترى الولايات المتحدة أن "نجاح دمج قوات قسد مع قوات الحكومة السورية سيؤدي إلى بيئة أمنية أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر استقراراً".
حجم الثروات ونوعها أيضاً عامل اختلاف بين التجربتين في العراق وسوريا، لطالما لعب النفط (الثروة الكبرى في العراق) دوراً مهماً في تحريك السياسات وتغذية المنافسات المحلية والدولية، بالتالي تشكل النزاعات، تقوية الاعتمادية، والتراخي في الاستثمار بتنمية المجالات الاقتصادية الأخرى. يتحدّد دور هذا العامل في المعادلة داخل سوريا مقارنة بالعراق، فما يوجد في العراق لا يوجد مثيله في سوريا، هذا من جانب. من جانب آخر ينخفض عنصر النفط في سلم الأولويات للدول المشرفة على التغيير في سوريا لصالح بيئة اقتصادية تحتضن التجارة الحرّة والاستثمار الصناعي والعقاري والزراعي بأمان.
هذه الاختلافات لا تعني أن البلد لا يمر بمرحلة حرجة، ولا ينكر أنه يواجه تحدّيات متعدّدة المستويات، أمنية (حماية الحدود، مكافحة الإرهاب، وكبح التهديدات الداخلية والخارجية)، وسياسية (بناء نظام سياسي قوي مدعم ومتماسك، الاستجابة لمطالب سياسية متفاوتة من كافة الأطراف عبر نموذج يضمن تلبية مصالح الجميع، تحقيق أمن واستقرار مستدامين، وبناء الثقة بين الشعب والسلطة)، واقتصادية (التحرر من العقوبات الدولية، إنعاش الاقتصاد، جذب الاستثمارات، تقليص نسب الفقر، وتحقيق التنمية المالية والاقتصادية والبشرية)، واجتماعية (رفع الحيف عن المظلومين، ومحاسبة المدانين بالاجحاف وقمع الشعب، امتصاص الغضب والغبن اللذين خلفتهما الممارسات التعسفية خلال الحرب وإعادة بناء الثقة بين مختلف المكونات).
والأكيد هنا رغم كل المعطيات أن السوريين (على المستويين السياسي والجماهيري) هم العامل الأول والأقوى في توجيه البلاد إلى المسار الصحيح.

 اكتظاظ قرب مقهى النوفرة الشهير في دمشق - الجبال
اكتظاظ قرب مقهى النوفرة الشهير في دمشق - الجبال