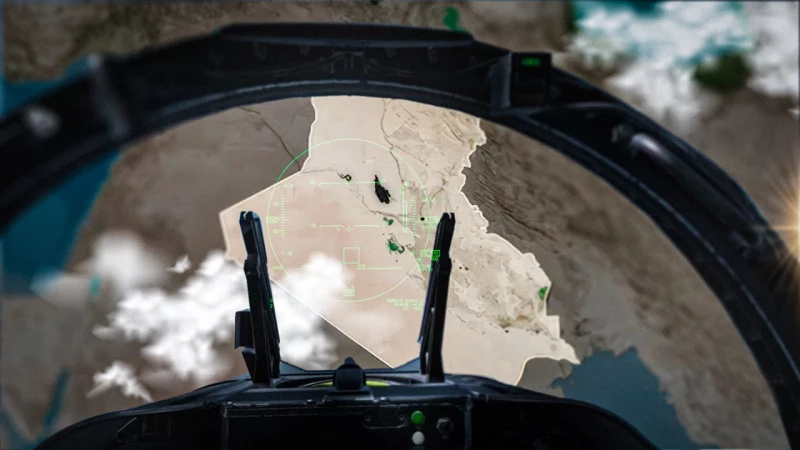أغرب التعليقات في مواقع التواصل على حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء حجازي المشهداني بعبوة لاصقة، هي تلك التي تقول إنه حدث طبيعي، ويمكن أن يقع في أحسن بلدان العالم، أي أنه حادث أمني لا يخدش حالة الاستقرار العام التي ينعم بها البلد.
الغرابة في هذا التعليق، الذي يدافع أصحابه فيه عن الوضع القائم أو عن المجرمين المحتملين – وأحياناً بدوافع طائفية – تكمن في أنه يتجاهل السياق العام. فالحوادث، سواء أكانت جنائية أم إرهابية، حين تقع في بلدان العالم المتحضّر، تُلاحق قانونياً، وغالباً ما تُلقي السلطات القبض على الجناة، حتى ولو بعد أربعين سنة، كما حصل في قضية جيمس إيوكا.
فخلال شغب ديترويت العنيف عام 1967، ألقى جيمس "بودي" إيوكا قنبلة مولوتوف على واجهة متجر، مما أدّى إلى حريق قُتلت فيه امرأة عجوز تدعى هولين كاري، وسط احتجاجاتٍ لحقوق الإنسان ضد التمييز العنصري. هرب إيوكا لأكثر من ثلاثين عاماً إلى كاليفورنيا بهويةٍ مزيفة، قبل أن يُقبض عليه عام 1999، ويُحكم عليه بالسجن عشرين عاماً، ثم أُفرج عنه مشروطاً عام 2017 قبل وفاته عام 2019.
نعم، لا يمكن منع الجريمة تماماً، لكن ما يُشعر المواطنين بالأمان ليس استحالة وقوع الجريمة، بل وجود ملاحقة قانونية حقيقية تضعف جرأة كثيرين على اقتحام عالم الجريمة، أما في العراق، فإن مقتل صفاء حجازي ليس مجرد حادثٍ ضمن النسبة المئوية "المعقولة" للحوادث التي تقع في أي بلدٍ مستقر، بل هو تذكير مؤلم بأننا لم نغادر عام 2006 بعد.
والسبب أن كثيراً من الحوادث المماثلة أُغلقت ملفاتها ضد مجهول، وحتى تلك التي شُخِّص فيها المجرم وظهر على شاشات التلفزيون، أُطلق سراح الجناة فيها لاحقاً، كما في قضية مقتل الناشط إيهاب الوزني أو هشام الهاشمي.
الأمان والاستقرار، في هذا السياق العراقي الخاص جداً، يعنيان أن المجرم والخارج على القانون "يسمحان" بوجود استقرار، لا لأن سلطة القانون قوية أو قادرة على كبح الجريمة.
وما عدا بيانات الاستنكار والشجب الصادرة عن الحكومة والبرلمان ومجلس محافظة بغداد، لم تُتخذ حتى الآن أي من الخطوات المطلوبة لإلقاء القبض على قتلة صفاء حجازي.
ويبدو أن رئيس الوزراء لا يريد الانشغال، في شهر الدعايات الانتخابية، بمهام رئيس الوزراء، إذ ارتضى لنفسه موقع "المرشّح الانتخابي" الذي يلاحق مؤتمراته في المحافظات. وحتى لو كان الأمر من باب الدعاية الانتخابية، فإن رئيس الوزراء لا يريد توريط نفسه في هذه القضية.
وأقصد أن يقوم صاحب أعلى سلطة تنفيذية بإنفاذ القانون ومجابهة الجناة أياً كانوا – وهو من المهام الطبيعية لرئيس الوزراء – فيتحول هذا العمل إلى أفضل دعاية انتخابية ممكنة. لكن رئيس وزرائنا لا يريد الدخول في هذه المواجهة التي تنطوي على شبهة استقطاب سياسي، وقد تجرّ عليه مضارّ أكثر من منافع في شهرٍ حساسٍ للغاية.
إن رئيس الوزراء، مثل غيره من الزعماء السياسيين أصحاب القوائم الانتخابية، يعوّل على جمهوره الخاص، وهو جمهور أنتجته علاقات زبائنية محددة. ولا يفكر هؤلاء الزعماء بتلك الدعاية والنفوذ اللذين يأتيان من تأدية المهام الدستورية، بل يتعاملون معها انتقائياً، ويتجنّبون المعارك التي يعرفون منذ البداية أنهم خاسرون فيها.
وهي تجربة خاضها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إذ ذهب برجليه إلى معارك خاسرة من أجل إنفاذ سلطة القانون، مثل إلقاء القبض على مطلقي الصواريخ في ألبو عيثة، أو قاتل إيهاب الوزني. لقد خسر في تلك المواجهة، لكنه قدّم موقفاً وأمثولة. الموقف هو: أن رئيس الوزراء، أيّاً كان، يستطيع أن يقوم بعمل مماثل، وأن ذلك ليس مستحيلاً، أما الأمثولة فهي: تعرية نظام الميليشيات المسيطر على البلد، الذي لم يعد عمله في الخفاء والكواليس مجدياً.
لا يريد السيد السوداني أن يخوض هذه المواجهة الآن... أو ربما يريد أن يدّخرها إلى ولايته الثانية المأمولة.

 (صفاء المشهداني ـ مواقع التواصل)
(صفاء المشهداني ـ مواقع التواصل)